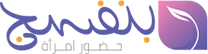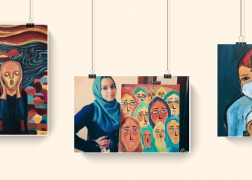ثمّة فرق شاسع بين ما يخبرنا به الرجال عن الحرب، وما تسرده النساء؛ فالذاكرة النسائية أشدّ قوة، أشدّ ألمًا، أشدّ رهبة، ذات ألق، وطعم ورائحة، وألم، وكلّ الثقل، وكلّ التضحية. هناك اهتمام بالغ بالتفاصيل والمشاعر والجانب الإنسانيّ الآخر من الحكاية البعيد كلّ البعد عن شعارات النصر، ومبرّرات الحرب، ومواقع الهجوم؛ إذ لا يهمّ الرجال ما إن كانت هناك فردة حذاء لطفل صغير فوق حشد من الجثث، ولا ما إذا اقتحم الجنود بيت شيخ طاعن في السنّ وهو يؤدّي صلاته. أما النساء فيكسبن صوتًا لهذه المواقف، ويحُزن على قدرة رهيبة في رؤية ما هو مغلق أمام أعين الرجال.
| وجه الحرب

تقول إحداهنّ: "دخلت على باب المديرية بفستان، وخرجت من باب آخر بسروال وبلوزة، وقصّوا جدائلنا، وأبقوا على رؤوسنا غرّة من الشعر". وتضيف أخرى: "احتفلنا بزواجنا في الخندق قبيل المعركة، أمّا ثوب الزفاف فقد خطته بنفسي من مظلّة ألمانية". هل كان الرجال سيعرضون هذه التفاصيل في شهاداتهم؟ المشكلة أنّ ذاكرة الحرب لطالما كانت بمنظور الرجال وتصوراتهم، أمّا النساء فيلذن بالصّمت، لأنهنّ بشكل أو بآخر يرين بأنّ هذه الحرب لا تعنيهنّ، إنهنّ يكرهن الموت، ويتحمّلن مخاض الولادة، ويحملن الحياة، فكيف يجرؤن على القتل؟
هل ستكون للحرب التي تقصّها النساء أثر أبلغ إذن؟ وهل ستكون أقرب إلى الحقيقة من وجهة نظر إنسانية؟ هذا ما أرادت تأكيده الكاتبة البيلاروسية الحائزة على جائزة نوبل "سفيتلانا أليكسيفيتش" في روايتها، "ليس للحرب وجه أنثوي" التي نشرتها سنة 5198 متخذة من مآسي النساء في الحرب العالمية الثانية مادّة لها. أرادت أن تجمع روح الإنسان التي انشطرت إلى شظايا متفرّقة متطايرة، وتعيد تتبعها، ملتمسةً أثر صدى النساء، وأصواتهنّ، وشهاداتهنّ، فتفجّر جميع العواطف التي وإن كانت مزوّدة بالألم والدموع، غير أنّها حقيقية رغمًا عن كل شيء.
كلّفت هذه الفكرة الكاتبة سبع سنوات من حياتها، كما تذكر في الرواية: سبع سنوات عجاف من البحث، واللقاءات، والتقصّي، والتسجيل، والترحال، ومحاولة اقناع النساء بالإدلاء بالشهادات، واضطرار العيش مع حقيقة الموت، ومأساة القتل والوجه البشع للحرب. خلصت منها بحقيقة عبرت عنها في مطلع الرواية قائلةً: "اكْتَشف أنه في الحرب، بالإضافة إلى الموت، ثمّة أشياء أخرى كثيرة كما في حياتنا العادية؛ فالحرب هي أيضًا حياة. أصطدم بعدد لا يحصى من الأسرار والحقائق الإنسانية، أفكّر في مسائل لم نفكّر سابقًا في وجودها، مثلًا: لماذا لا نستغرب وجود الشرّ؟".
| دخلتُ بضفيرة... وخرجتُ من دونها

تضمّن الكاتبة في الرواية شهادات حيّة لنساءِ شاركن في الحرب العالمية الثانية، مع صفوف الاتحاد السوفياتي: كُنّ ممرضات، ورقيبات، وقناصاتِ، وطبيبات، وعاملات لاسلكيّ، ومراقبات... تختلف المهمات والنتيجة واحدة. لم تغفل الجندية ماريا عند حديثها مع الكاتبة عن هذا التفصيل: "دخلت بضفيرة، وخرجت من دونها". كأن المدخل الذي عبرته في أول يوم جنّدت فيه كان بوابة لحياة جديدة، مختلفة عن سابقتها، ذات إطار خاصّ، ومن دون ضفيرة.
إنسان ما قبل الحرب لا يشبه إنسان ما بعد الحرب في شيء؛ ثمّة ملامح خاصّة لا يمكن تجاوزها، ثمّة طقوس ستظلّ محفورة في الذهن. "حاول أن تجد إنسانًا جيّدًا في الحرب"، تسوق الكاتبة هذا الطلب بنبرة تحدّي، ويبدو أنّ الإفلاح في إيجاده هو في حدّ ذاته إنجاز كبير، بعد أن يغدو معظم من شهدوا الحرب أشخاصًا غير الذين ألفناهم، وعرفناهم. لعلّ مردّ ذلك يعود إلى أنّ المعاينة المستمرّة لمظاهر البؤس تقسّي القلب، كما يقول جان جاك روسو، لعلّ للأمر سبب آخر.
كيف تعود النساء بعد الحرب؟ هناك صعوبة في التأقلم، واضطراب دائم، وإحساس بالتناقض، ودموع تتجمّع مع كلّ ذكرى. تعرّفنا الكاتبة على هذا الوضع مع شاهدتها الثانية، تقول بأنّها كانت تجد صعوبة في ارتداء التنورة، والمشي بالحذاء النسائيّ. لقد غدا كلّ شيء مدنيّ وعادي أكثر صعوبة. "في الجبهة كنّا دومًا بالبنطلون، نغسله مساءً، ونضعه تحتنا، وننام عليه... كيف عليّ أن أتعلّم المشي بالتنورة؟ أشعر وكأنّ رجلاي مشبكتان". الحرب تسلب من المرء صورته، تفقده هويته، تتركه من دون ضفيرة!
اقرأ أيضًا: "لما بدت الحرب": شهادات من العدوان الأخير على غزة
تراهن شاهدة أخرى على ورقتها الأخيرة بعد استشهاد أمها أثناء القصف، وتجد من القتال في الجبهة خيارها الوحيد. عجبًا، كيف يحدث أن تصبح الحرب ملاذ من لا ملاذ له؟ تصرّ أخريات على الالتحاق رغبة في الدفاع عن الوطن، أو إسعاد أهلهنّ. الحرب في النهاية مليئة بالتناقضات: تسيل دموع أمهات البعض غزيرةً مترجيةً لهنّ ألا يغادرن، في الوقت الذي تمتلئ فيه وجوه الآباء بالفخر أمام القرية: ابنتي في الجبهة!
كان أصعب شيء بالنسبة للممرّضة ماريا مشهد بتر الأعضاء. وكانت على صعوبة ذلك المشهد تحمل الرجل المبتورة بحرص، وهدوء شديدين، كمن يعتني بطفل صغير، كمن يقطف وردة ربيعية، من دون أن تلفت انتباه الجنديّ الموضوع تحت أثر المخدّر. العضو في النهاية جزء لا يتجزّأ من الفرد، وكل نسيج فيه هو بطريقة أو بأخرى نسيج للذاكرة. لم تنسَ ماريا هذا المشهد، مثلما لم تنسَ صديقتها مشهد قصّ الضفيرة. الرِّجْل كما الضفيرة، لا يعود المرء بعدها كما كان من قبل.
| قلب هذه الفتاة... يحترق!

لم تعد الفتيات في الجبهة يخشين شيئًا، أصبحت الحرائق والشظايا، وأصوات الدبابات، ورصاص الأسلحة جزءًا من سمفونية حياتهنّ اليومية. احترقت شورا إثر قذيفة مباغتة، كان بإمكانها أن تنقذ نفسها، لكنّها لم تستطع أن تترك الجرحى وتنفذ من الحريق، تقول عنها صديقتها بأنّها كانت الأجمل بينهنّ.
تشتكي هذه الصديقة ذاتها من كثرة الرتب في الجبهة، حتّى المفاهيم التعريفية تختلف بين عالم النساء وعالم الرجال، كان عليها أن تحفظ كلمات مثل الرقيم، والملازم، والرائد، لكنّها لم تكن لتستسيغ كلّ هذه التعقيدات، وكانت تكتفي بعبارة بريئة: "عمّي، يا عمّي، إنّ عمي هناك طلب منك تسليم هذا الطلب". كيف سرقت الحرب من هؤلاء الفتيات براءتهنّ؟
أن تبقى المرأة رهينة الصمت لبقية حياتها. قلب هذه الفتاة يحترق... لكنّها لا تعيره انتباهًا، يكفيها أنّ الحرب انتهت!
تبحث هذه الصديقة عن صديق لها احترق جسده بالكامل، وفقد بصره، لكنّه تعرّف عليها بمجرّد فتحه للباب، وإمساكه بيديها، تعرّف عليها بعد ثلاثين سنة. "أمّه طاعنة جدًّا في السنّ، عاش معها... وهي طيلة حياتها تقوده من يديه". كيف عرفها يا ترى؟ هل وصلته رائحة قلبها الذي احترق منذ زمن؟ تسأله نينكا عن آخر مشهد لا زال يتذكّره: مشهد احتراق الدبابات، يجيبها. لا شيء سوى ألسنّة اللهب، لا شيء سوى الحرائق.
تكتشف الكاتبة في غضون ذلك أنّ ما يبدينه النساء عكس ما يخفينه. هناك دائمًا شخصيتان تتصارعان، وغالبًا ما تغلب الشخصية المتأقلمة على قرينتها الحقيقية. لا يمكنّ لهنّ أن يكنّ صريحات إلى النخاع إلّا في حالات محدودة؛ إذ لا يستطيع المرء أن يكشف عن صفحات أيام مليئة بالتناقضات، والتجاوزات، والأخطاء، والآلام، أمام من يعتبرهنّ بطلات، وهذه في حدّ ذاتها مأساة أخرى: أن تبقى المرأة رهينة الصمت لبقية حياتها. قلب هذه الفتاة يحترق... لكنّها لا تعيره انتباهًا، يكفيها أنّ الحرب انتهت!
| في هذا البيت...حربان

هناك حربان في هذا البيت، تقول الكاتبة، حرب الزوج وحرب الزوجة. كلاهما كان في الجبهة وسردا لها تفاصيل الحب. الحرب لم تمنع أحدًا من أن يحب، لقد كانوا يرون في هذا الوجدان الإنساني بريق الأمل الذي يمكن أن ينقذهم من ذلك الجحيم. وكانت صلته مختلفة عن أي حب غيره: بين خطوط النار، وأصوات القذائف، صلة راسخة لا يمكن لشيء آخر أن يمنعها.
الحكاية هذه المرة مختلفة، لم تلتحق أولغا بصفوف المعركة بطوع إرادتها، ولكنها سيقت إليها قصرًا بسبب النزوح، وهناك التقت زوجها. يبدو الأمر صعبًا في ظل وجود ذاكرتين في المنزل نفسه، يوجد دائمًا شيء ما يذكر أصحاب البيت بتلك الأيام، عند كل نظرة وتقسيمة وجه، عند كل صدى صوت. "أنا أشعر أن زوجتي لها حربها، ولي حربي. كان لدي شيء شبيه بما روته لك في البيت، أو كيف أن النساء وقفن في طابور لشم رائحة زميلتهن". لكن الزوج يفضّل سماع ما تقصه زوجته، لأنه بشكل ما يشعر بأن كلماتها أكثر صدقًا وأقرب للحقيقة، حتى إنه يقتطع من قصصها ويرويها لأحفاده.
هذه هي المأساة الحقيقية، أن تصبح الحرب جزءًا من الحياة، جزءًا مغروسًا بشراسة ولا يمكن انتزاعه أبدًا. أولغا تريد أن تنسى، كان بودها أن تعيش يومًا واحدًا من دون الحرب، لكن بدا ذلك مستحيلاً. من بعيد، يختفي الزمن. تظهر عجوز مسنّة تقارب التسعين من عمرها، معلقة على صدرها إعلان الفقد كما في الأيام السابقة التي تلت الحرب: "أبحث عن كولنيف توماس فلاديميروفيتش، لم يعثر عليه منذ عام 1942 في لينغراد المحاصرة". لا تزال تبحث عنه حتى اللحظة، رغم مرور السنين. من دفع الثمن غير الثكالى والأرامل، والنساء، والأمهات؟ هناك حكم بالإعدام، وهناك حكم بالسجن مدى الحياة، وهناك حكم بالنفي... وهناك حكم بالحرب.