بين مسميات وعناوين أخذت حجمًا ورواجًا كبيرًا لدى المهتمين بتربية الأبناء وتعليمهم، اختفى الدور الأكثر يسرًا وسهولة، وعظم شأن الأدوار الأكثر صعوبة والأشق في الجهد. فعكف الكثير من الآباء والأمهات على الاهتمام (بالتقانة) في تعليم أبنائهم، أو الاهتمام بالوسائل وإعداد وتصميم الأنشطة التعليمية، وتوفير الأدوات وكل أنواع الدعم المادي.
والمقصود بالتقانة؛ الاهتمام بالأساليب والأدوات والتقنيات والمناهج والأنشطة وإعداد خطط وتجارب ومشاريع، في محاولة لمقاومة تأثير تداعيات عصر المادة والتكنولوجيا، متجنبين فيها الثقافة المدرسية وما تخلقه من أفراد غير مستقلين لا يمتلكون ملكات التعلم، وفي محاولة أيضًا لإيجاد بديل عن الجفاف الواضح في وسائل تربية الأبناء على القيم والمبادئ وفهم صحيح لدينه.
| فخ الثقافة المؤسسية ودور الوسيط

خلق كل هذا عبئًا إضافيًا على الأسرة، فأصبحت الأم هي المدرسة بالمعنى الحرفي للكلمة، وليس فقط كما وصف دورها الشاعر حافظ إبراهيم (الأم مدرسة إذا أعددتها .. )، فقد وجدت نفسها اليوم أنها المدرسة المسؤولة عن توفير البدائل من وسائل ومحتوى وإعداد وتصميم وتنفيذ، ناهيك عن دورها في عملها إن كانت تعمل، أو دورها في المنزل الذي عادة للأسف لا يشاركها فيه الرجل، فزادت عليها الضغوط، وتحول دورها بدون قصد إلى دور متأثر (بثقافة مؤسسية)، أو إلى دور الأم والأب، كوسيط تربوي، وكلاهما ابتعد بها عن روح التربية، التي كانت تخلقها أجواء الأسرة خلال الممارسات اليومية والتفاعلات بين أفراد المنزل الواحد والتي كان لها تأثير كبير على تشكيل هوية الفرد وشخصيته.
ففي الدور الأول (الثقافة المؤسسية) هناك الكثير والكثير من المعايير والتقييمات التي على أساسها يقيّم الأم/الأب دورهما مع أبنائهم طبقًا لمسطرة المؤثرات الخارجية من نماذج وتجارب ناجحة، وصور ومقاطع فيديو تبرز أمهات وآباء متميزين، فيقعون تحت ضغط المنافسة المحمودة لكنها مع الوقت تتحول إلى عبء، فيحاول الوالدين جاهدين لتحقيق ما يجب أن يحققوه، وإذا أخفقوا أو عجزوا عن ذلك، شعروا بالتقصير ويبدأ الشعور باللوم، وتبادل طلب الدعم من كل طرف، ويصبح نجاح الأبناء مؤشر لنجاح الآباء، و عدم وصولهم إلى طموح آبائهم مؤشر لفشلهم، مما ينعكس سلبًا على الوالدين في نظرتهم لأنفسهم ولكفاءاتهم وثقتهم في أنفسهم.
والثاني (دور الوسيط): الدور الذي وقع في فخ ضغوط ومتطلبات الحياة من توفير الدخل، والمظاهر الاجتماعية، وتحولت تربية الأبناء إلى عدد من النصائح والتوجيهات والأوامر والأدوار التقليدية؛ الأم لإعداد الطعام، والأب لجلب الأموال، والأبناء للقيام بالواجبات المدرسية والتمارين الرياضية. وفي هذه الحالة فالأم بين ضغوط عدم قدرتها على تحمل عبء إضافي وخاصة إذا كانت تعمل وتشارك في احتياجات الأسرة، وبين تأثرها بمفروضات اجتماعية حولت دورها التربوي إلى وسيط يدفع المال للمدرسين والمدربين والمؤسسات التعليمية ليقوموا بالدور الذي لا تستطيع القيام به.
باختصار أصبحت التربية متأثرة بـ ظاهرة (الإنجاز)، أي الرغبة في الإنجاز من أجل الإنجاز، أو كل ما له علاقة بـ (الحصول على..) الحصول على صورة جيدة تبرز مستوى اهتمام الآباء بأبنائهم، الحصول على ألعاب باهظة الثمن ومناهج وأدوات، الحصول على نتيجة مرضية، الحصول على درجة عالية، الحصول على أدوات وأنشطة مناسبة. هذا الجهد المحمود إذا كانت المبالغة فيه، بسبب (تأثير الصورة)، أو (السعي إلى المكانة الاجتماعية)، أو (الحصول على صك درجة عالية في سلم التعليم المفروض حديثًا) يحوّل الأجواء الحميمة في المنزل إلى طقوس جافة تزيد من الجفاف الذي شكلته هذه العوامل الثلاث وغيرها على الإنسان اليوم.
| الثقافة الأسرية: المنزل كمحضن تربوي وبيئة محفزة للتعلم
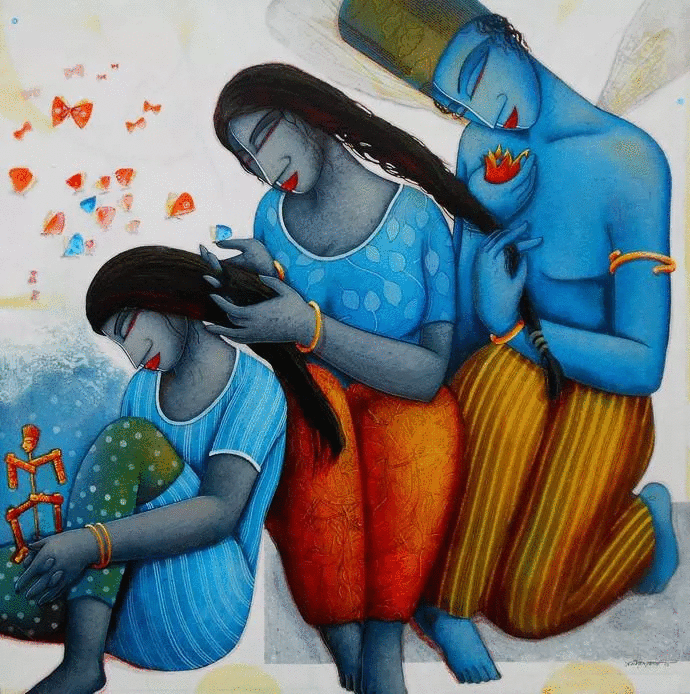
لم ينتبه الكثيرون إلى أن التربية أبسط وأيسر من أن يبذل فيها كل هذا المجهود الإجرائي والمادي والتقني والتسويقي التنافسي. فالعودة إلى الثقافة الأسرية حاجة ملحة إذن، أي عودة الأسرة والمنزل كبيئة محفزة للتعلم تشكل شخصيات أفراده كما يشكلون هم فيها مجتمعين. الأسرة كمحضن تربوي يتبادلون فيه كل أنواع الدعم النفسي والحاجة إلى الحب والشعور بالأمان والثقة، من خلال ممارسات يومية تلقائية خلال الأربع وعشرون ساعة، بشكل تلقائي وعفوي، أيًا كان وضع الأسرة الاجتماعي، وأيًا كان نوع التعليم ونمطه الذي اختاروه لأبنائهم.
العودة إلى الطقوس التربوية اليومية العادية، أي أن يكون لدى الوالدين قدرة على استثمار كل حدث يومي وترجمته إلى موقف تعلم، بدون الحاجة إلى التخطيط وبذل الكثير من الجهد والوقت والمال لإعداد أنشطة طوال اليوم. أن تكون التربية حاضرة في سلوك الآباء والأمهات وحواراتهم وهمساتهم وتقبيلهم لأبنائهم، فتصبح الحياة في المنزل كلها موقف تعليمي مستمر لا ينقطع، وغير مرتبط بوقت وجهد لإعداد نشاط أو أدوات معينة.
وبالتالي، إذا اهتمت الأسرة وبذلت جهدًا في ترتيب وتنظيم وإعداد بعض الأنشطة كانت هي مكملة لدور الأسرة الطبيعي والمتكامل بين أفراد المنزل، وليست هي كل الدور التربوي والتعليمي الذي يُقيَّم على أساسه ما بُذل من جهد. إضافة إلى تحول هذه الممارسات اليومية إلى (ثقافة الأسرة)، فيعتاد عليها الأبناء الكبار، ويقلدهم الصغار في هذه العادات والممارسات، ويصبح هذا ديدن الأسرة وروح المنزل وروتينه ولغته، فيقل العبء على الوالدين، بعكس الأنشطة والوسائل الأخرى التي لن تحقق ذلك منفردة.
| 24 ساعة من التربية ببساطة

في عصرنا الحالي نفتقد كآباء وأمهات هذه الملكة التي توفر عليهم الكثير من الجهد في تربية وتدريب الأبناء على القيم والمهارات الشخصية التي مهما حاولنا تعليمهم إياها عن طريق البرامج، أو الأنشطة، أو ألعاب المحاكاة، فلن تكون بنفس فائدة وأثر المواقف اليومية المتكررة وبنفس الأداء الذي يحوّل كل موقف إلى درس تعليمي غير مخطط له. وبدون جهد إضافي؛ كالحكي على مائدة الطعام في حوارات تهم كل فرد على حدته مما يعزز ثقة كل فرد من أفراد الأسرة بنفسه، ويُشعره بالاهتمام، مهما كان موضوع حديثه، ويدرب أفراد الأسرة على قيم التشارك وفهم الآخرين، بل وقد يكون الحوار مفيدًا ليتعرف على موضوعات جديدة.
حضن الأبوين وتقبيلهم للأبناء مع سرد قصة قصيرة قبل النوم، مع اختيار موضوع القصة، هو أفضل شيء يتأثر به اللاوعي قبل أن يخلد إلى النوم، ويشبع الطفل نفسيًا وعاطفيًا ويجعله متزنًا محبًا للغير، على عكس أطفال كثيرون يعبرون عن فقدهم لهذه العاطفة بمشكلات يفتعلونها مع أقرانهم. وكذلك اصطحاب الأب لأبنائه في الممارسات اليومية العادية لشراء احتياجات المنزل، أو لتصليح السيارة وترجمة هذه الزيارة إلى موقف في الفيزياء مع بعض المهارات والقيم الأخرى المرتبطة بتصوره عن الناس والمهن، وغيرها من الزيارات والجولات. واستثمار الواجبات الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية، أو التجمعات العائلية – بحسب المرحلة العمرية- وخاصة مع زيادة الساعات التي يقضيها الأطفال في المنزل بسبب الحجر الصحي، أو بسبب استخدامهم المفرط للأجهزة الإلكترونية.
هذا كله يؤثر إيجابًا على مهاراتهم الشخصية في التعامل مع الآخرين وبناء تصوراته عن العالم والناس والأشياء من حوله في حال كان الأبوين حاضري الذهن واستثمروا هذه المواقف وما تحمله في طياتها من تدريب على الحوار واستخدام ألفاظ التقدير والاحترام للكبير، كل ذلك يورث لدى الطفل القدرة على فهم الناس من حوله، وفهم مشاعرهم ومبادلتهم الشعور، واعتياد الأنس بهم وتجنبه أمراض الوحدة والغربة التي أنتجتها طبيعة الحياة التكنولوجية الافتراضية الحالية.
هذا الفهم الفطري للدور التربوي للأسرة ككل، يضمن أن يشعر كل فرد من أفراد الأسرة بقيمته والاهتمام به، وخاصة الأم التي ستشعر رغم ما تبذله من جهد أنها لم تفقد شخصيتها واهتماماتها في زحمة هذه الأعباء، ولن تسأل نفسها بعد سنوات: أين أنا من ذلك كله؟













