في تمرين السباحة، وبينما الأطفال يخضعون لقواعد التدريب الصارمة، والأمهات، كما العادة، بانتظارهم، يتبادلن الخبرات التربوية والتعليمية، وبالطبع الوصفات المطبخية، في حالة من التباري غير المفهوم، يكون فيها الأبناء عادةً دلائل وبراهين على نجاح هذه الخبرات ونجاعتها، فوجئنا جميعًا بأصوات الدهشة قادمة مع أطفالنا وهم يلتفون حول فتى صغير لم يتجاوز الثماني سنوات على الأكثر. حمل الأطفال صاحبهم، الفتى اللامع، في نظرات الانبهار والفخر حتى وصلوا إلينا بالخبر السعيد، وأعينهم تكاد من فرط الفرحة تدمع، يمتلك الصغير "قناة مقالب على اليوتيوب" يتابعها العشرات، لكنها، بمزيد من الكدّ والاجتهاد من صاحبها، في طريقها لمضاعفة أعداد متابعيها! ثم حدث ما لا يحتاج إلى كثير من النباهةِ لتوقعه، في صوت واحد يشبه كورالًا محفوظًا وجدت الأمهات أنفسهن أمام الطلب المنتظر: ماما أريد أن أُنشئ قناة على اليوتيوب؟ لماذا؟ لكي أصبح غنيًا ومشهورًا!
| أريد قناة يوتيوب يا أمي
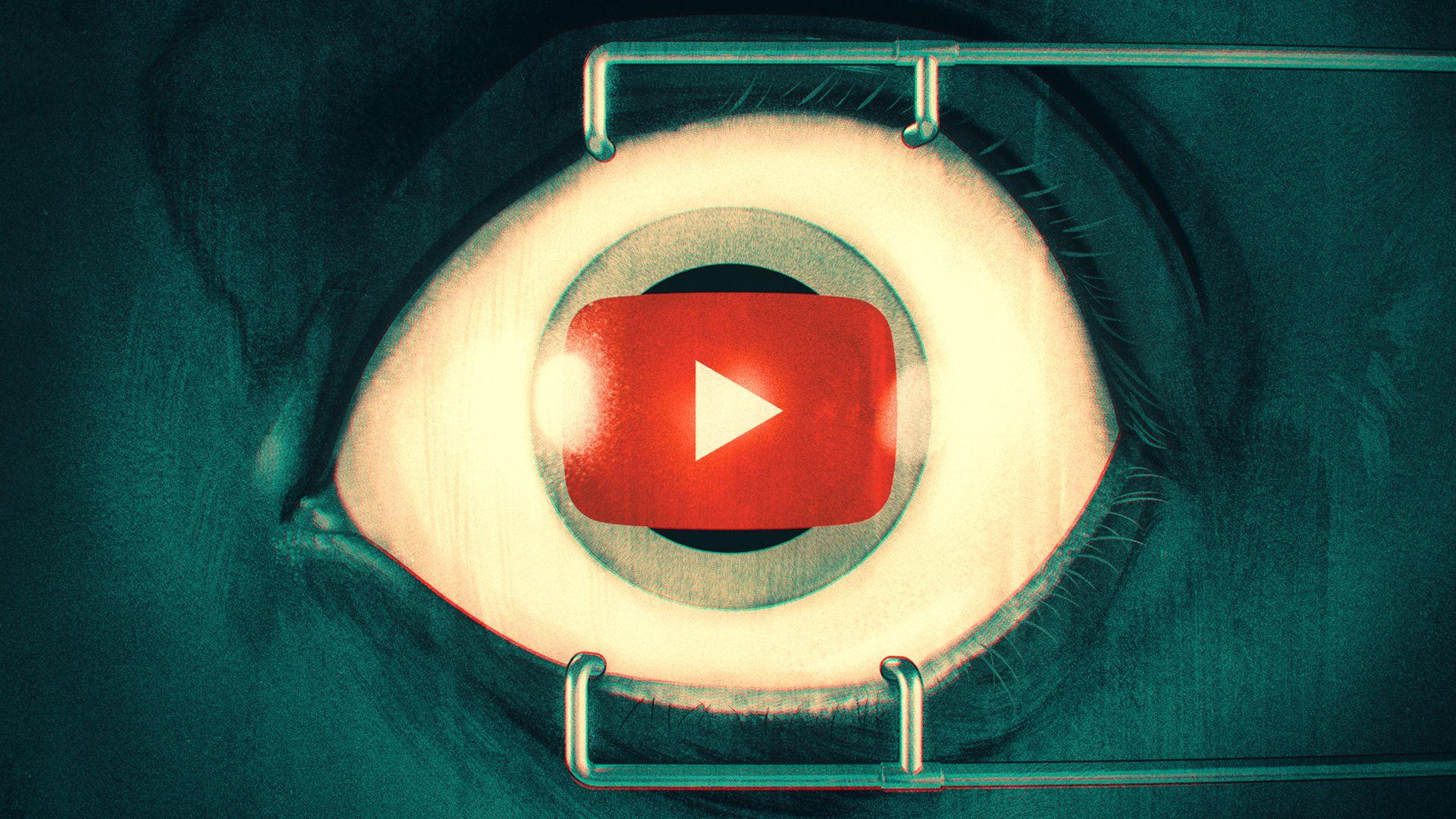
تباينت ردود الأفعال، لكنها على اختلافها، أفصحت عن السؤال الأهم؛ السؤال المحمّل بالفزع أكثر من الاستفهام: متى نبت في وادينا الطيّب أمنيات الشهرة والمال على هذا النحو؟ كيف تحوّل وعي الأطفال من خيالات القوى الخارقة، ومحاولات إنقاذ العالم من أساطين الشر، وبسط سيطرة الخير والعدل إلى هذا الحديث المخيف عن اقتناء كل ما هو ثمين، وتملّك أحدث السيارات، وجوب العالم بطائرات خاصة؟ أين ذهبت أحلام سبيستون يا أصدقائي؟!
هذا السؤال على خِفّته، مخيف ومعقّد، لكن دعونا نمسك بطرف خيطه، منطلقين من "اليوتيوب" ورواده من "اليوتيوبرز"، حيث تختبر الأسرة نمطًا جديدًا من الرسائل الإعلامية غير المراقبة كليّة، والتي تعتمد بصورة رئيسية على الطفل كصانع للمحتوى، أو بطل أساسي فيه، وبالوقت نفسه هو المتابع/ المشاهد الأول له.
يتكوّن وعي الطفل من خلال ما يُعرف بـ"التنشئة الاجتماعية"، هذه التنشئة التي تحوله من كائن بيولوجي إلى فرد اجتماعي يرتبط بمحيطه العام من خلال أواصر الثقافة والتعليم والتربية، في إطار مجموعة من التفاعلات المتشابكة التي تقوم بها مؤسسات مثل الأسرة والمدرسة والإعلام، حتى تنتهي به إلى فرد ناضج قادر على إدارة عمليات التكيّف الاجتماعي وفق مجموعة المفاهيم والقيم التي يتبنّاها، ومن ثمّ تتحدد هويته الشخصية وكذلك معاييره الأخلاقية. بمعنى آخر تنتج عملية التنشئة "النظارة" التي يرى الإنسان بها العالم من حوله، وكيف يتعاطى معه أخذًا وردًّا.
| نظرية الغرس الثقافي

بالحديث عن الإعلام، موضوع هذا المقال بالتحديد، فيجادل باحثوه من خلال نظرية "الغرس الثقافي" لـ جورج جربنر، أن للإعلام بمنصاته المختلفة دور فاعل وحيوي في عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد عامة والأطفال بصفة خاصة. تفترض نظرية جربنر أن التعرّض للمحتوى الإعلامي يجعل الفرد أكثر قابلية لتبنّي معتقدات اجتماعية تتماثل مع الصورة التي تقدمها المنصات الإعلامية عن الحياة الواقعية، بحيث ترتبط هذه القابلية إيجابيًا مع كثافة التعرّض، فكلما زاد الوقت الذي يقضيه الإنسان أمام الشاشة كلما كان تمثّله وتوحدّه مع ما الرسائل التي تقدمها أكثر.
حسب استطلاع أجرته مجموعة إن بي دي البحثية الأمريكية، فإن ٤٠٪ من الأطفال الذين بلغوا ١٤ عامًا أو أقل، يشاهدون مقاطع فيديو على اليوتيوب مرة أسبوعيًا، على الأقل، من بين هذه المقاطع المصورة نَما أكثر فأكثر المقاطع التي تعتمد على الأطفال كعناصر أساسية في المحتوى الذي تقدمه، خاصة تلك التي تقدم محتوى "عائليًا" يعتمد على نقل يوميات تلك العائلات، والتي غالبًا ما تأخذ شكلا ترفيهيًا بتجربة ألعاب جديدة، أو صنع "مقالب وتحديات" بين أفراد الأسرة في أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة والإثارة، لا تشبه، ولا يمكن أن تشبه، الأجواء العائلية الطبيعية التي يعيشها الأطفال مع أسرهم يوميًا، وهذا أول الخطر حيث تقدم هذه القنوات للطفل تصورًا خاطئًا أو قاصرًا في أفضل الأحوال عن الطبيعة المتوقعة للحياة.

كما أن الاستعراض اليومي للحياة المرفهة المليئة بالألعاب والفنادق والسفر، تلك التي يستطيع الأب أو الأم أو كلاهما التواجد الدائم ضمن أجواء مرحة لا يعكّر صفوها أي انضباط تربوي أو تعليمي، إلاّ ما يأتي في إطار اللعب والفكاهة، لا يمكن أن يستقيم والحياة الطبيعية التي يعيشها الطفل يوميًا بين أسرته، والتي لا يمكنها بحال من الأحوال أن تتشابه مع هذه التي يراها على الشاشة يوميًا، ففضلًا عن الإمكانات المادية العالية التي لا تتوافر لغالب الأسر، فهناك أيضًا الوقت والرفاه النفسي، وغياب الانضباط والكثير مما لا يتسق، وحياة نعيشها ضمن أسرة ومحيط اجتماعي واسع، فيه من الضغوط والصعود والهبوط ما يجب أن يعايشه الطفل ويدرك أبعاده، ليتهيأ لحياته القادمة وما فيها من مسئوليات وأعباء حقيقية.
الأمر الثاني، والذي يتكون مع "كثافة المشاهدة" وانحسار دوائر العلاقات الاجتماعية، لا سيما في هذه السن الصغيرة، هو تحول شخوص عالم اليوتيوب إلى أصدقاء متوهمين في عقل الطفل، فينشأ الطفل هذه الرابطة الوهمية التي تجمع بينه وبين هؤلاء الفتيان خاصة مع وجود عناصر المشابهة في السن واللغة، وما يبدو للطفل من انكسار حاجز الافتعال، الأمر الذي ينعكس على الرغبة في "المحاكاة" على المستويات القيمية والسلوكية.
وهو ما أكدته دراسة حديثة نشرتها مجلة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال جاء فيها أن ٧٨٪ من الأطفال الذين يشاهدون مقاطع "عائلة مشيع"، قد أبدوا رغبتهم في الذهاب للأماكن واقتناء المنتجات التي جاءت في هذه المقاطع، كما أن أكثر من نصف الأطفال عقدوا مقارنات بين نمط حياتهم وما يمتلكونه وبين ما يظهر في حلقات عائلة مشيع.
| طوفان لا نهاية له

لا تعطي هذه النتائج مؤشرًا هامًا حول هاجس "المحاكاة" الذي يسيطر على الطفل ويعتبر "الشرائي" منه أدنى درجاته، لكنها أيضًا تنبّه إلى الفهم المغلوط الذي يقدمه هذا المحتوى عن معانٍ مهمة مثل السعادة والرضا المعيشي، حيث يحصره قسرًا على "الاستحواذ والتمّلك" الاستهلاكي، فينصّب اهتمام الطفل نحو "الشراء" كقيمة عُليا ونهائية، بغض النظر عن مدى استمتاعه بما يشتريه، أو قدرته على الاستفادة منه، فضلًا عن تراجع رضاه وتكيّفه مع واقعه المعيشي والمادي الذي ينتمي إليه.
وهنا يأتي دور الخيال والتطلعات، فإذا كان الواقع قاصرًا عن الإيفاء بمتطلبات السعادة التي يراها على الشاشة من شراء لا محدود ورفاه معيشيّ غير متحقق في بيئته الاجتماعية، فلنذهب إلي الباب السحريّ، اليوتيوب، أو أي باب آخر من شأنه أن يحقق لنا ما نراه على الشاشة، ومن ثمّ تتراجع الأحلام الطفولية الوردية، هذه التي نستقي من غضاضتها وبراءتها لمراحلنا اللاحقة ومسؤولياتنا المنتظرة، لصالح مجموعة محدودة من الأحلام العِجاف التي تتمحور حول الشهرة والمال بشكل رئيسي وحصري، ويصبح مفهوم النجاح مقرونًا فقط بتحقيق أعلى قدر من الشهرة، وأكبر قدر من المال، بغض النظر عن أي اعتبارات قيمية أو أخلاقية أخرى.
يبدو أنه لا نجاة كاملة من هذا الطوفان، لا يمكن بسهولة أن تقاوم عروضًا يومية للمرح الذي لا ينتهي، والرفاه المعيشي الذي يظهر يسيرًا من خلال بعض "الألعاب والمقالب"، والكثير من الأريحية من الوالدين، كما لا يبدو المنع التام حلًا حصيفًا، حيث لم يعد بالإمكان إحكام غلق النوافذ وحجب الرؤية الكامل، ومن ثمّ لم يعد أمامنا سوى إدارة حوار رصين وهادئ مع أولادنا قادر على الصمود أمام هذه الموجات المتتالية من الخلخلة المفاهيمية والقيمية، وبذل الجَهد في هذا الاتجاه باعتباره طوق النجاة الرئيسي في هذا الطوفان.
| مصادر المقال
[1] https://samc.ksu.edu.sa/sites/samc.ksu.edu.sa/files/imce_images/ldd_rqm_26.pdf
[2] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00094056.2020.1796459?scroll=top&needAccess=true
[3] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02567/full
[4] https://www.bbc.com/arabic/business-51726344














